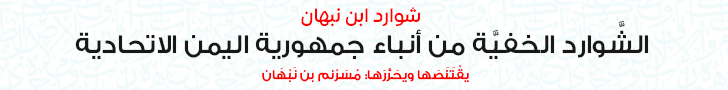في كل عام، ومع اقتراب 22 مايو، يعود الجدل حول الوحدة اليمنية. فريق يراها “ثابتًا وطنيًا” لا يجوز المساس به، وآخر يعتبرها تجربة فاشلة تستحق المراجعة. لكن ما يغيب عن هذا السجال المتكرر هو العنصر الأهم: المنطق السياسي.
لا أحد ينكر أن لحظة إعلان الوحدة في 1990 مثّلت تطلعًا نبيلاً، استجابت له إرادة سياسية ووجد قبولًا شعبيًا واسعًا، لا سيما في الجنوب الذي بادر بالخطوة تحت ضغط ظروف سياسية واقتصادية خانقة. غير أن الحلم لم يُبنَ على أسس متينة: لا في توزيع السلطة، ولا في إدارة التعدد، ولا في ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية.
ثم جاءت حرب 1994 لتقضي على ما تبقى من ذلك التوازن الهش، وتحولت الوحدة من “شراكة بين نظامين” إلى “غلبة طرف على آخر”؛ وهي لحظة الانكسار التي مهّدت لمسار الانهيار المتدرّج.
منذ ذلك التاريخ، لم تُبنَ مؤسسات دولة حقيقية، بل جرى تفكيك ما تبقى منها من الداخل، حتى جاء الحوثي، وأسقط العاصمة صنعاء، وفرض سلطته بقوة السلاح، لتدخل البلاد في مرحلة انهيار شامل.
في هذا الواقع، يصبح من غير المنطقي أن نناقش “الوحدة” وكأنها لا تزال قائمة فعليًا. فاليمن اليوم مقسّم بين سلطات أمر واقع، وجيوش متنازعة، ومشاريع سياسية متصارعة. حتى الجنوب – الذي لطالما وُصف بـ”المحرر” – لم يخرج بعد من دوامة التنازع السياسي والأمني، بل يشهد صراعًا داخليًا بين مكوناته المختلفة.
نعم، الوحدة مبدأ دستوري. لكنها ليست نصًا جامدًا يُستدعى عند الحاجة، بل مشروع سياسي لا تكتمل شرعيته إلا عبر قبول شعبي متجدد، وشراكة متوازنة، ومؤسسات تُدار بعدالة وتمثيل. فلا وحدة قابلة للحياة دون رضا عام، ولا دون دولة تضمن المواطنة المتساوية لجميع أبنائها.
أما “الانفصال”، فليس حلًا سحريًا بديلًا، ما لم يأتِ عبر عملية تفاوضية شاملة، تُنهي المرحلة الانتقالية، وتؤسس لكيان سياسي مستقر، لا مجرد تكرار لخطابات مناطقية تفتقر إلى مشروع جامع.
الخلاصة أن الدولة اليمنية القديمة – بوحدتها المركزية وهياكلها المتهالكة – لم تعد قابلة للاستمرار. والحل لا يكون بالتمسك الأعمى بالماضي، ولا بالاندفاع العاطفي نحو المجهول، بل في إنتاج صيغة وطنية جديدة، تستند إلى التوافق، وتُقِرّ بالوقائع، وتُعيد تعريف “الدولة” على أسس هذا القرن، لا على أوهام القرن الماضي.
من صفحة الكاتب على منصة إكس