هشاشة البنية السرية.. تحليل: انهيار أساطير الحوثي بين ضربات الخارج وفساد الداخل
تقارير - Tuesday 28 October 2025 الساعة 09:33 am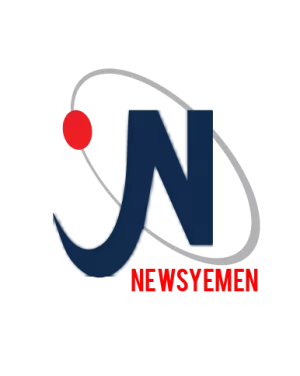 صنعاء، نيوزيمن، خاص:
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
لم يكن الحوثي يومًا يُظهر كل أوراقه للعامة؛ فمعسكراته السرية التي صُقلت بعناية داخل مناطقه الخاضعة لسيطرته لم تكن معروفة إلا لعدد محدود من القيادات، وكانت هذه المنشآت — من مواقع تخزين ومصانع ميدانية للطائرات المسيّرة والصواريخ إلى معسكرات تدريب وتجنيد خاصة — تُعدّ مدار إنجاز استراتيجي يعتمد عليه في المناورات الداخلية والمصالحات الإقليمية. اعتمدت الجماعة لسنوات على هذا النسق السري لإبقاء قدراتها القتالية مخفية، ولضمان وجود "مخيّم احتياطي" لا ينكشف أمام عيون الخصم المحلي.
لكن مع تعرض هذه البنى لضربات دقيقة أُعدّت بمعلومات استخباراتية عملت عليها واشنطن وتل أبيب معًا، انكشفت هشاشة البناء الذي اعتُمد عليه. لم يقتصر الأمر على تدمير مواقع مادية فحسب، بل شمل ضرب مراكز قيادة وعناصر لوجستية حيوية، ما أدّى إلى مقتل وجرح قيادات عسكرية بارزة وتشظٍ في شبكات الاتصال والتزويد. وقد أفضت هذه الضربات إلى تعطيل خطوط الإمداد، فضحّت مخازن أسلحة ومسارات تهريب كان يعتقد الحوثي أنها "آمنة"، وأضعفت قدرته على السيطرة الميدانية وإدارة الملف الأمني داخل مناطق نفوذه.
النتيجة كانت أكثر من مجرد خسائر عسكرية: انهارت بعض رواسب الشرعية التي استند إليها خطاب الجماعة عن "الجاهزية" والدولة البديلة، وتراجعت روح الانضباط لدى قواعده، ما فتح الباب أمام تصدع التماسك الداخلي واندلاع صراعات نفوذ بين أجنحة القيادة وحملات اعتقال متبادلة، في حين بدأت الأجهزة الأمنية في ضبط إيقاعها بوسائل أقل ثقةً وأكثر قسوةً لتعويض فراغ السلطة المركزية.
الصاعقة التي فضحت الأوهام
منذ نشأته، برع الحوثي في إدارة حروبه على الأطراف، لا في قلب مناطقه. كانت استراتيجيته تقوم على مبدأ "القتال البعيد"؛ أي نقل المواجهات إلى محافظات خارجة عن نطاق سيطرته المباشر مثل مأرب والجوف وتعز والحديدة، ليتفادى أي تهديد داخلي قد يهز سلطته في صعدة وصنعاء وذمار. هذا التكتيك منحه شعورًا زائفًا بالتفوق والسيطرة، وسمح له بتغذية دعايته حول كونه “القوة القومية” التي تحمي اليمن من "العدوان الخارجي"، بينما هو في الحقيقة يُخوض معاركه داخل جسد اليمن نفسه. لقد جعل من الحرب ضد اليمنيين وسيلة لتوحيد الداخل بالقوة، ومن التوسع العسكري بديلاً عن الإدارة الرشيدة أو الإصلاح البنيوي في مناطقه.

غير أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة جاءت لتقلب تلك المعادلة رأسًا على عقب. فالهجوم الذي استهدف عمق معاقله الخاصة لم يكن مجرد عملية عسكرية عابرة، بل كان بمثابة “زلزال استخباراتي” ضرب ثقة الحوثي في حصونه، وأصاب منظومته القيادية في الصميم. فقد أظهرت الضربات أن كل ما بُني على مدى سنوات من التمويه والتدريع والسرية لم يكن سوى واجهة رخوة مكشوفة أمام أجهزة استخباراتية تملك من الدقة ما يكفي لاختراق أكثر دوائر الجماعة تحصينًا. مقتل شخصيات عسكرية رفيعة وتدمير مراكز اتصال ومنشآت عسكرية حساسة أثبت أن الحوثي كان يعيش في وهم “التحصين الكامل” بينما كان في الواقع عاريًا أمنيًا أمام خصومه.
لقد كانت تلك المواجهة الأولى له داخل نطاق سيطرته اختبارًا قاسيًا لمدى صلابته الحقيقية. فالجماعة التي طالما تباهت بأنها “تتحدى العالم” وجدت نفسها فجأة عاجزة عن حماية معاقلها الأساسية. سقطت أقنعة القوة، وتكشّف الخوف في صفوف عناصرها الذين أدركوا أن القصف لم يأتِ من بعيد عشوائيًا، بل من قلب المعلومات التي يعرفها فقط الصف الأول في القيادة. وهكذا، انطبق عليه المثل الشهير: أسدٌ على اليمنيين، ونعامةٌ أمام الخارج. لقد كان الحوثي قويًا في معاركٍ صنعها بنفسه، لكنه هشٌّ ومربك في معركة لم يخطط لها ولم يختر زمانها ولا مكانها.
الكاتب والمحلل السياسي نبيل الصوفي قال إن "الضربات الأميركية التي استهدفت معسكرات ميليشيا الحوثي السرية فضحت أمرًا بالغ الأهمية أنها لم تعِدْ بعدُ ترميم بنيته الخفية كما يظن، والمعسكرات التي كان يعتبرها مخابئ آمنة لم تكن معروفة إلا لقلة من قياداته—وهذا ما جعلها عرضة للاكتشاف والتدمير. ما حدث يُظهر أن الاعتماد على السرية المطلقة كان رهانًا خاسرًا حين تواجه قوة استخباراتية عالمية أو إقليمية."
وأضاف: "والأدهى أن الضربة الإسرائيلية جاءت كصاعقة: دقيقة ومبنية على معلومات لا يملكها إلا لاعبان كبيران هما واشنطن وتل أبيب. تلك الضربة لم تقصر في تدمير مواقع فقط، بل ضربت صميم الهيكل القيادي واللوجستي، وكشفت أنه كلما حاول الحوثي أن يعمم صورته كقوة مؤسساتية، يكون عاجزًا عن حماية ما يزعم امتلاكه داخليًا."
عودة الجماعة على حساب الدولة
عندما أُعلن عن تعيين يوسف المداني في موقع قيادي حساس بصنعاء، لم يكن الحدث مجرد تغيير إداري داخل بنية السلطة الحوثية، بل كان بمثابة إعلان صريح عن انتهاء مرحلة “الدولة” وعودة الجماعة إلى أصلها العقائدي والمناطقي. فبعد سنوات من محاولة الظهور بهيئة كيان سياسي منظم يمتلك مؤسسات وهيئات “رسمية”، جاءت عودة المداني لتؤكد أن منطق “المكتب السياسي” و”المجلس الأعلى” ليس سوى واجهة زائفة، تُخفي وراءها صراعًا محتدمًا على النفوذ بين أجنحة متناحرة، لكل منها ولاءاته وتمويله وارتباطاته الخاصة.
هذا التعيين لم يُقرأ داخل الأوساط الحوثية كخطوة إدارية عادية، بل كإعادة تموضع حقيقية، حيث عاد القرار إلى الدائرة الأسرية والولاءات القديمة التي تحكمها العصبية والمصالح، لا الكفاءة أو التنظيم. فـ"المداني"، المعروف بولائه الشخصي لعبدالملك الحوثي وبتشدده في إدارة الجبهات، لم يأتِ ليعيد الانضباط، بل ليعيد فرض السيطرة عبر التخويف والتهديد. منذ الأيام الأولى، بدأ بإطلاق رسائل تحذيرية ضد “الطامعين في المناصب”، في إشارة واضحة إلى منافسيه داخل الجماعة، وعلى رأسهم “الرزامي” وبعض القادة الميدانيين المحسوبين على جناح “الخيواني” و”عبدالكريم الحوثي”.
وبموازاة ذلك، تم إطلاق يد علي حسين الحوثي ليكون الذراع الميدانية الجديدة في معادلات النفوذ داخل صنعاء، الأمر الذي أعاد إشعال خطوط الصراع القديمة بين أبرز مراكز القوى داخل الجماعة: عبدالكريم الحوثي، عبدالحكيم الخيواني، مهدي المشاط، محمد علي الحوثي، وأحمد حامد. هذه الصراعات ليست مجرد تنافس على المناصب، بل صراع وجود بين أجهزة استخباراتية ومؤسسات مالية وإعلامية، كل منها يدير موارد خاصة وشبكات مصالح داخلية وخارجية.
ومع تفاقم هذه الانقسامات، تآكلت فكرة “الدولة الحوثية” التي حاولت الجماعة تسويقها خلال السنوات الماضية. لم يعد هناك مؤسسات قادرة على صنع القرار أو إدارة الموارد بشكل مركزي، بل أجهزة متصارعة تتجسس على بعضها وتعتقل عناصرها. فكل جناح يرى في الآخر تهديدًا وجوديًا، ما دفع القيادة العليا إلى الاعتماد على التبديلات المستمرة والاعتقالات الدورية كوسيلة لإعادة ضبط الولاءات، في مشهد يعكس ضعف السيطرة المركزية وانهيار البنية التنظيمية التي طالما تباهى الحوثي بانضباطها.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي نبيل الصوفي: "مع عودة يوسف المداني إلى صنعاء تتبدل اللعبة: لم يعد الحديث عن دولةٍ قادرة على الإدارة، بل عن استعادة منطق الجماعة والولاءات. التعيين أثار فتيل صراعات قديمة بين أجنحة أمنية وسياسية، وها نحن نرى اعتقالات متبادلة ومحاولات لفرض هيمنة عبر شبكات الولاء لا عبر مؤسسات الدولة. هذا التحول يُعيد صنعاء من عاصمةٍ موعودة إلى ساحة ولاءات وصراعات داخلية."

بهذا المعنى، لم يعد الحوثي اليوم جماعة تمتلك مشروع دولة، بل شبكة مصالح أمنية ومناطقية تتنازع فيما بينها على السلطة والثروة. فكل قرار يُتخذ داخل صنعاء بات نتاج توازنات خوف لا توازنات قوة، والعودة إلى “الحكم الجماعاتي” تمثل، في جوهرها، اعترافًا غير معلن بأن فكرة الدولة التي حاول الحوثي ترويجها لم تكن يومًا أكثر من وهم سياسي يخفي تحت عباءته حقيقة المشروع: إمارة عقائدية محصورة في يد عائلة واحدة.
تموّه ضعف الحرب المباشرة وتوظيف الحروب بالوكالة
مع تردد واضح لدى قيادة الحوثي في الانخراط في حرب شاملة داخل مناطقه — نتيجة للخسائر، والضغوط الاستخباراتية، وتآكل البنية اللوجستية — برزت لدى قادته فكرة تشغيل حروب بديلة عبر أدوات طرف ثالث. أحد السيناريوهات المطروحة يكمن في تنشيط خلايا مسلحة وإرهابية في مناطق الشرعية أو توجيه مجموعات محلية مأجورة لتنفيذ هجمات تخريبية واستفزازات تهدف إلى إشغال القوّات الحكومية وإرباك المشهد الأمني دون أن تُحمّل الجماعة مباشرة تبعات المواجهة.
هذه الاستراتيجية، التي يمكن وصفها بـ«التكتيك بالوكالة»، تخدم هدفين عمليين في نظر الحوثي: أولاً، تقليل الانكشاف العسكري المباشر للقيادة ومقارّها الحساسة، وثانياً، إحداث انزلاق أمني في عمق المناطق المحررة يشتت الموارد والجهود ويخلق مناخًا سياسياً يبقي خيارات الجماعة مفتوحة. تقنياً، يمكن أن يتضمن هذا المسار توظيف شبكات محلية من المطلوبين، استغلال مهربين لتسهيل تنقّل الأسلحة، أو حتى إعادة استيعاب عناصر أفرج عنهم سابقًا لإعادة تفعيلهم تحت لافتات مناطقية ودعائية.
لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر ويتحمل تبعات استراتيجية خطيرة: أولاً، قد يؤدي إلى تفجير مواجهة تستنزف القوى المحلية وتطيل أمد القتال في الجبهات المحرّرة، وتضعف القدرة على استرجاع الأرض وإعادة المؤسسات. ثانياً، تشغيل خلايا إرهابية يفتح الباب أمام اتساع رقعة العنف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتبعثر المسؤولية القانونية والسياسية، مما يجعل المساءلة الدولية أصعب لكنّ تأثيرها الإنساني أعظم — إذ يدفع المدنيون ثمنًا باهظًا من تهجير واغتيالات وهجمات على مرافق مدنية.
على الصعيد الداخلي للحوثي نفسه، اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يعكس اعترافًا ضمنيًا بالعجز عن خوض معركة تقليدية ناجحة؛ لكنه في الوقت ذاته يعمّق هشاشة تماسك الجماعة لأن الاعتماد على وكلاء خارجيين يولّد ديناميكيات لا تخضع للقيادة المركزية بسهولة، وقد ينقلب التكتيك على أصحابه إذا تحوّل الوكيل إلى كيان مستقل أو خرج عن نطاق السيطرة.
إقليمياً ودولياً، ستستدعي مثل هذه الخطوة تكثيفاً في التعاون الاستخباراتي والعقوبات ضدّ شبكات التمويل والتهريب، وقد تسرّع في عزلة الجماعة سياسياً. كما سيضع هذا المسار ضغوطًا أكبر على الجهات الداعمة أو الوسطاء — خاصة دول الجوار — لإجبار الحوثي على العودة إلى مفاوضات أو دفع ثمن سياسي أوسع لتمويل أو احتضان أدواته.
ويرى الكاتب والمحلل الصوفي: "في المعادلة الراهنة يسود فزع واضح داخل صفوف الجماعة: المداني يراهن على وساطة خارجية—عمانية مثلاً—لتقنين علاقة الجماعة مع القوى الدولية، وفي المقابل يلجأ إلى خيارات أخرى لطمأنة قواعده، منها تفجير مواجهات بالوكالة داخل مناطق الشرعية عبر خلايا وعناوين متفرقة. هذا المسار ليس حلاً، بل اقتراب من استراتيجية مخاطِرة تُبدد بقايا مشروع الدولة وتعرّض اليمن لموجات عنف جديدة."
إن تموّه الحرب المباشرة عبر وكلاء وعناصر إرهابية قد يبدو حلًا تكتيكيًا لإخفاء الضعف، لكنه في واقع التطبيق استراتيجية قصيرة نظر ذات تكلفة إنسانية وأمنية وسياسية مرتفعة، وقد تكون بذرة لتفاقم الأزمة بدلًا من أن تكون مخرجًا لها.
الإغلاق على الدولة والرهان على الجماعة
هذا التحول من خطاب الدولة إلى حكم الجماعة لا يقتصر على مجرد تبديل في الأسماء أو المناصب، بل هو تحول منهجي في طبيعة الحكم. بدلاً من بناء مؤسسات منتخَبة أو إدارية تُنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بحكم القانون، صار المشهد في المناطق الخاضعة للحوثي يدور حول شبكات ولاءات أسرية ومناطقية وعسكرية تُدار بمنطق "المنفعة والمحاصصة". القرار لا يُتّخذ عبر آليات مؤسساتية شفافة، بل عبر توازنات داخلية بين أجنحة عائلية وأمنية، تتحكّم في الموارد وتوزّع المنافع وفق منطق الولاء لا الكفاءة.
أذرع التنفيذ في هذه البنية لا تعمل كمؤسسات خدمية، بل كآليات تجنيد وابتزاز: نقاط تفتيش وجبايات وضرائب غير نظامية، مصادرات ممتلكات، عقود تشغيل وامتيازات اقتصادية تُمنح لأنصاف رجال موالين، وقنوات إعلامية وقضائية تُستخدم لتقويض المعارض أو إقصائه. هذه الأدوات تؤمّن تمويلًا سريعًا للقيادات وتكريسًا لولائاتها، لكنها تقوّض أي احتمال لاستعادة دولة فعلية قادرة على تقديم الخدمات العامة أو احترام الحقوق.
النتيجة الاجتماعية فادحة: المواطن لم يعد يتعامل مع سلطة توفر حوائط حماية وخدمات، بل مع منظومة تسيطر على كل مفاصل الحياة عبر الخوف والرهان على الولاءات. في مقابل ذلك تُصغّر الرموز والمؤسسات الرسمية — وزارات، إدارات محلية، مؤسسات قضائية — إلى أدوار شكلية أو تختفي تمامًا في الواقع العملي، لأن منطق المحاسبة والشفافية غير مرغوب فيه أو مرفوض داخل تركيبة الحكم الجماعاتي.
اقتصاديًا، هذا الانغلاق يولّد ما يمكن تسميته بـ«اقتصاد الاقتسام»؛ حيث تحتكر شبكة قيادية موارد طبيعية وعقود استثمارية وتهريب وقنوات توزيع، مع الاستفادة من صفقات حماية وعمولات، ما يبعد رأس المال المنتج ويخفّض فرص الاستثمار الشرعي ويزيد من البطالة والفقر. سياسياً، يُنتج النظام محظورات أمام أي مساعٍ لإصلاح مؤسسي أو إعادة دمج مؤسسات الدولة، لأن الإصلاح يهدد مصالح شبكات الاستئثار هذه.
ومع تفاقم الاعتماد على منطق الولاءات، تزداد بدورها سلطة أذرع التجنيد والابتزاز الأمنية — ويمتد تأثيرها إلى التعليم والدعوة والثقافة، حيث تتحول المؤسسات إلى آلات لإعادة إنتاج الولاء العقائدي أو العسكري. وهذا يعمّق الانقسام الاجتماعي ويجعل مسارات المصالحة أو إعادة الدمج أكثر تعقيدًا؛ إذ لا يعود التحدي تقنيًا (بناء مؤسسات)، بل سياسيًا وأخلاقيًا (تفكيك شبكات المصالح وإعادة بناء ثقة المجتمع).
أمنيًا واستراتيجيًا، رهْنُ السلطة بالجماعة يمثّل سيفًا ذا حدين: من جهة يمنح قيادة الحوثي قدرة على تحريك موارد وإخضاع منافذ، لكنه من جهة أخرى يُسهل ظرفية التفكّك حال احتدام الصراعات الداخلية أو تصدّي ضغوط خارجية، ما قد يؤدي إلى تفتيت السيطرة إلى وحدات محلية متناحرة أو إلى تداعيات عنفية داخلية.

